علامات الفكر المتهافت [1]: بناء الأحكام على علل غير عللها الحقيقية.
لكلِّ حقيقة لوازمها وعلاماتها الدّالة عليها والتي تُعرف بها، والفكر المتهافت علاماته كثيرة.
أحدها: بناء الأحكام على العلل غير المناسبة عقلاً وواقعًا، وقد يكون ذلك عن ضعف في قوّة الإدراك، أو عن جهل بصورة الموضوع، أو عن هوى يصدُّ عن الجهة الموصلة إلى العلم الصَّحيحِ.
وهذا الأمر - البناء على العلل غير المناسبة - قائمٌ بالفكر العلماني على وجه راسخ في شأن تعليلهم لتصرُّفاتِ المتديّنين من المسلمين، وما هم عليه من أحوال.
فتارة يعلّلون ذلك بأنّه موجَب الفقر والحاجة والتّهميش، وهذا كان قولهم في تعليل تصرفات الشّباب الذين يفجّرون أنفسهم، وعندما أثبت الواقع أنَّ من هؤلاء الشّباب من هم أرباب الثّراء والمال والجاه؛ قالوا على هذا التّصرف: إنَّ شيوخهم يعدونهم بالزَّواج من الحور العين في الجنَّة.
وعلى قطعٍ، يعلم كلّ ذي بصيرة أنَّ هذا القول ضرب من الهذيان الذي يلفظ به المبرسمون.
إذ واقع الإنسان النّفسيّ الطبيعيّ يشهد أنّ هذا التّعليل يجافيه ويباينه تمامًا، إذ لا يتأتّى في مجريات العادة أن يكون الشّبَق موجبًا لهذا العمل وإن بلغت قوّته ما بلغت.
وهب أنَّ هذا كان صحيحًا؛ فهل يُعوز ذا الشّهوة البهيميّة هذه أن يجد مطلبه في هذا الزّمان على أقصى ما يريد؟
الجواب عن هذا معلوم، وهو النّفي.
ثمّ إنّ العلّة العادية الأصلُ فيها الاطّراد، فلو كانت هذه الشّهوة توصل إلى أن يفجر نفسه لنيلها؛ لكان العلمانيّون أولى بذلك لما قام بهم من الغلمة التي أفضت بهم إلى الانحلال المطلق، والواقع يشهد على ذلك، فهل ينكـَر ما قام الحسّ والتّجربة بإثباته.
أما تراهم لا ينفكّون يعادون على هذا الأمر ويوالون عليه، 'والحب والبغض في الانحلال والفساد من العلمانيّة'.
وعلى هذا السّنن العجيب في التّعليل مضوا في تعليل هذه الصّحوة الدّينيّة الّتي تزعجهم، فتارة يعلّلونها بأنّها موجب تدفّق أموال الخليج، ويكاد المرء يصاب بالغثيان من هذا الهذيان، إذ ما علاقة تدفّق المال بالمادّة الرّوحيّة القائمة بالقلوب المؤمنة، والسّلوك الحسن القائم بجوارحهم، والمتطلبات المعرفيّة الّتي لا تقتنع العقول إلا بوجودها، وذلك ـ الاقتناع ـ لا يكون إلّا بصحّتها، فهل إعطاء المال للمرء يترتّب عليه كلّ هذه الأشياء المعنويّة المعرفيّة الرّوحيّة العلميّة، ثمّ هل كانت هذه الأشياء قائمة بنفوس أهل هذا البلد على مدى التّاريخ الإسلاميّ أم كان هذا شيئًا حادثا؟!
سبحان الله العظيم! هذا بلد الإسلام، لا يحتاج أهله إلى مال أحد لكي يظهروا حقيقتهم.
ثمّ إنّه لو كان المال يعطي هذا لكان مكتسبًا من المال الذي يؤخذ من محاربي الدّين الإسلاميّ، وبيته صناديق دعاة التّغريب، الذين يستمتعون به، ويوهمون المانحين بأنّهم قد أفلحوا في تغريب المسلمين، وإن حُدّثوا بهذه الصّحوة المباركة استروحوا إلى أنَّ هذه سحابة صيف عن قريب تقشع.
وهكذا حال كلّ التّعليلات العلمانيّة لأعمال المتديّنين وأحوالهم بلا استثناء، سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
وسبب هذا الخطأ والتّخبّط لدى هؤلاء العلمانيّين في هذا الشّأن كونهم يعلمون ظاهرا من الحياة فقط، وقياسهم الخلق على أنفسهم، وذلك مبنيٌّ على جهلهم بحقيقة الإنسان، وبأنّه مركب من مادّة وروح، وأن سلطانهما جار عليه بالتّوازن والاعتدال إن كان سويًّا، وأمّا إن كان على خلاف ذلك فإنّه يتخبّطُ في عماية وجهالة.
فالمتنطّعُ المتشدّدُ في الدّين مطويّ على وقدة الجانب الوجدانيّ الموجّهِ بالجهلِ، والمتفلّتِ من الضَّبْطِ الفقهيّ الإسلاميّ، فمال به ذلك إلى الخروج عن حدّ الاعتدال وإلى الوقوع في أمور مهلكة له ولغيره.
وقد يكون ذلك منه عن شعوره بالإهانة والاحتقار من دعاة الانحلال والفساد بوجه ما، مصحوبًا بما تقدَّم ذكره من الجهل المُرَكَّبِ بشرائع الإسلام وشعائره الذي ارتداه وتأزّرَ به، تلك الشّرائع الّتي من أصولها وجوب حفظ نظام العالم على سنن مستقيم يتحقّق به العدل والفطرة، وحفظ الضّروريات الخمس؛ وهو ما لا يتوصّل إليه إلّا بالجدال بالّتي هي أحسن، والدّخول في السّلم الشّامل العامّ وبيان متجلّيات عظمة الإسلام والنّعم المتجلّية المكنونة فيه، والظّاهرة.
والّتي منها ـ كذلك ـ البدء بتطهير المرء نفسه وتزكيتها من الرُّعُونَاتِ ورذائل الصّفات، وجعل ذلك غاية غاياته فيما هو ساع إليه ومجدّ فيه، قبل إصلاح غيره.
وهو خلاف ما عليه هذا الصّنف من النّاس، إذ قصارى أمرهم التّجريح للنّاس والبحث عن العيوب لنشرها طارحين مقتضيات الأدلّة الشّرعيّة الحاكمة بضدّ ما هم عليه.
وإذا سألتهم عن موجب هذا الذي هم عليه أجابوا بعلل لا وجود لها ولا قرار إلاّ في مخيّلاتهم المستمدّةِ من تصوّرات فاسدةٍ، والممدّة من مادّة أمزجة نفسيّة مضطربة لخلوّها من زمام فقهيّ صادٍّ عن الوقوع في الزّلل والخطأ.
ومن تأمّل هذا بإنصاف آخذًا بمقتضيات الواقع حال هؤلاء أدرك هذا الأمر على جلاء.
وأمّا العلمانيّ فإنّه لمّا كان غير عابئ بالجانب الرّوحي، أو غير مدرك لحقيقة أمره كان فكره على وَفْقِ ذلك، فكان لا يتخطّى إدراكه الجانب المادّي في البشر، فكلّ شيء يصدر عن البشر ـ في نظره ـ مصدره هذا الجانب، فكان ذلك مبلغه من العلم.
والحقيقة الّتي قد تزول الرّاسيات وهي لا تزول؛ هي أنّ الإنسان مزدوج التّركيب من المادّة والرّوح، وأنّ معجزته الوجدان، كما يشهد بذلك الواقع والعيان.
ودراسة هذا مبدأ النّظر الصّحيح لمن له رغبة في معرفة حقيقة الإنسان.
فيجب أن تفهم حقيقة الإنسان وتتصوّر على ما هي عليه أوّلا قبل الحديث عن تعليل تصرّفاته والكلام عن أحواله.
ـ المنهج الصّحيح في النّظر في حقيقة حال المؤمن والعلمانيّ المتمرّد من حيث التّعليل لحالهما:
منطلق النّظر يجب أن يكون من أمر المغايرة النّفسيّة بين الطّرفين، بحيث يكون مبدأ النّظر والبحث في موجبات هذه المغايرة وعللها.
ويجب أن يكون كلّ واحد من الطّرفين ملزما بالجواب عن علّة أو علل هذه المغايرة، فمن كان منهما يملك الجواب المعتضد بالواقع والبراهين العقلية المنتزعة منه؛ فهو الذي إلى قوله المصير، ويكون قول مخالفه ساقط الاعتبار.
والعلمانيّون قد سمعوا وهم يدّعون أنّ علّة الاختلاف هو أنّهم أرباب فكر ونظر، وأنّ غيرهم من هؤلاء المتديّنين تعطّلت عقولهم، فلم يشتغل فيها إلاّ المنطقة الخياليّة التي نتاجها الخراف.
وبعضهم يرى أنّ المتديّن مريض مرضًا نفسيّا، وأنّه محتاج إلى "العلاج النّفسي".
ولهم آراء أخرى في هذا الشّأن من جنس هذا الذي ذُكِرَ، لا تخرج عنه.
ولا يخفى أنَّ هذا الضّرب من التّعليل غير مقبول لفقده صفة المطابقة والصّلاحيّة في الإسناد، إذ من شرط العلّة العادية الصّلاحيّة العاديّة، فالنّظر الصّحيح والفكر المستقيم لا يصحُّ أن يجعلا علّة في أمرٍ بدون الجريان على مقتضاهما، والمضيّ على سبيلهما الذي يحصل ويقعُ بالتّرتيب للمعلومات والحجج البالغة للتّوصل إلى المطلوب.
وهذا أمر لم يحصل من هؤلاء ولا صدر منهم، وإن كان موجودًا حقًّا فأين صورته، ومن أين أخذت مادّته.
ثمّ إنّ ادّعاء كون العلمانيّين أرباب فكر ونظر صحيح مصادرة على المطلوب ومغالطة تصدم الحقيقة، والبرهان العقليّ والواقع شاهد على ذلك.
وأمّا كون المسلم المتديّن مريضًا مرضًا نفسيًّا فلوازم المرض النّفسيّ تُنْكِرُ هذا، وتشهد على خلافه.
فالمصاب بالمرض يفقد الانضباط، والسّلوك المستقيم ويتخلّف عن الإدراك المعرفيّ لما هو مصلحة له ممّا هو مفسدة له، ثمّ إنّه يميل إلى الانتحار غالبا لفقده الاطمئنان ولغلبة الكئابة وشدّة الخوف عليه.
هذه بعض لوازم المرض النّفسيّ، فمن الذي هو الأحقّ والأولى بالاتّصاف بهذه الأوصاف اللاّزمة لهذا المرض، المسلم المتديّن، أم العلمانيّ الملحد؟
من الذي لا يجد الرّاحة النّفسيّة إلاّ إذا أغرق نفسه في أوهام السّكر وخيالات المخدّرات، وأتون الموبقات؟
اسألوا الواقع، وانظروا في واقع وحال كلّ واحد من الطّرفين بإمعان؛ تدركوا الجواب القاطع.
المحتاج إلى هذه المهدّئات حقًّا لتنتظم أمور حياته بوجه ما؛ هو غير المسلم المتديّن، أحصوا من يردون الخمارات والحانات، ثم انظروا من هم، وبعد ذلك اسألوا هل هم مرضى يتوقّف زوال ألمهم ـ وإن كان ذلك عارضًا ـ على شرب هذه السّموم المهلكة للعقول والصّحة، أم لا؟
المتديّن بعيد عن هذا، لأنّه مستغن عنه بمادة أخرى وهي المادّة الرّوحيّة الفطريّة المصلحة للنّفوس والأبدان، نافر منه، فانظروا إليه، وأمعنوا النّظر في حاله، ولا تكونوا كالذين صدّهم إلف الإعراض عن النّظر في الدّلائل الواقعيّة، وصرفهم الاعتياد على عدم التّأمل عن نزع الأحكام من أدلّتها الشّاهدة عليها.
فالمعلولات لا تكون إلاّ عن عللها، والعلل يجب أن تكون فيها القوّة والقدرة على إظهار ما ينسب إليها من معلولات، وهذا يعلم ثبوته وعدمه من واقع حال المعلولات، وحال عللها.
وما ثبت في العيان وحكمت به مقتضيات العقول، يجب المصير إليه على كلّ حال، ولا يكابره إلاّ من يعاند الحقائق، و ينكر الضروريّات العقليّة.
العلّة الحقيقيّة لمغايرة حال المؤمن للعلمانيّ المتمرّد:
أمّا من جهة العلمانيّين الملحدين فإنّ علّة ما هم عليه هي إنكار لحقيقة اقتضتها العقول والآيات القائمة بالخلق الموجبة لها، وهذه الحقيقة هي جريان ملك الخالق وسلطانه على خلقه تدبيرًا وتشريعًا.
هذا الإنكار الذي يعدّ ظلمًا لأنّه جحد لحقٍّ ثابت عقلاً وواقعًا، هو الموجِبُ ـ بالكسر ـ لما عليه قلوب هؤلاء العلمانيّين من أحوال.
والاقتران الدّائم والتّلازم بين هذه الأحوال وهذا الموجب ـ العلّة ـ وكذلك التّضادّ الحقيقيّ بينه وبين الأحوال المضادّة لهذه الأحوال دليل قاطع على هذا الذي ذكر.
فكلّ ما يجلب أمرًا معيّنًا ويدفع ما يضادّه هو علّة حقيقيّة في هذا الجلب وهذا الدّفع، وهذا يدرك بدلالة الواقع ومقتضيات العقول.
والممكنات لا تأتي ولا توجد بذواتها، بل بالعلل المناسبة لذلك، عقلا، وواقعًا، وهي الّتي فيها المناسبة الخاصّة الصّالحة بذاتها لذلك الإيجاد، ولكلّ شيء حقيقته القائمة به، والخصوصيّة الذّاتيّة تقوم بهذه الحقيقة بالطبع، كما هو معلوم في مجريات العوائد واطّرادها.
فقيام الأشياء بالتّدبير والتّقدير يوجب الملك والسّلطان للمدبّر المقدّر، ومقتضى ذلك أنّ له التّشريع والقضاء على جميع خلقه، إذ لا يجري سلطانه وموجب ملكه حقًّا تامًّا إلَّا بذلك، وما سوى ذلك بتر ونقص مستحيل جريانه في مقتضيات العقول باعتبار أنّ السّلطان المطلق لا يتمّ إلاّ بهذا، ولا يحصل إلاّ به.
إذا تقرّر لديك هذا الأمر عرفت على قطع أنّ موجب ما عليه هؤلاء المنكرين لحقائق الدّين من أحوال نفسيّة ونظريّة وسلوك مضطرب معذّب هو هذا الإنكار، وهذا الجحود والعناد الّذي هو في واقع الأمر ظلم فاحش، كما تشهد بذلك الأدلّة الواقعيّة.
قد يشمخ أحدهم بأنفه إذا سمع هذا القول، ثمّ يرغي ويزبد صارخا بأنّ هذا تفسير دينيّ وهو غير مرضيّ بالنّسبة لنا معشر العلمانيّين "أرباب الفكر الخالص" ثمّ إنّنا لسنا مرضى، ولا معذّبين، وقلوبنا أحوالها طيّبة، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا.
وفي الأخير يبتسم مستهزئًا إن كان في جمع، ثمّ يختصر كلّ هذا الذي ذكر في عبارة "الفكر الرّجعي".
والحقُّ أنّ هذا ليس مستغربًا، ممّن لا يريد أن يدرس حقائق الأشياء على ما هي عليه من حال، كما يريد بحث النّسبة الّتي بين الأشياء الّتي يرد بعضها عقب بعض باطّراد وتلازم، بل من لا يعرف جهات الدّلالة في المدركات المادّيّة والمعنويّة، ولا في الأمور المترابطة فيما بينها، ولا أنّ الموضوع فيه مجمل، وأنّ المحمول هو الّذي يبيّنه بالطّرق النّظريّة الموجبة له.
ومن تأمّل بإنصاف هذا التّفسير فإنّه سيجده مدركا بطريقة السّبر والتّقسيم، والنّظر المجرّد، إذ قد نظر في جميع ما قد يكون على وجه الإمكان علّة لهذا الحال الّذي عليه هؤلاء المنكرون للشّرع الإسلاميّ، فما وجد شيء استجمع شرائط العلّة لهذا الأمر إلاّ الّذي ذكر، لأنّه مطّرد معلوله، كما أنّه منعكس ـ أيضا ـ وهذا أمر مقطوع به بمقتضى الأدلّة الواقعيّة الّتي لا ينكرها إلاّ سوفسطائيّ يجحد البدهيّات.
علّة أحوال قلب المؤمن:
المؤمن الملتزم علّة ما هو عليه من حال حقيقته هو الإقرار بالملك والسّلطان للخالق المدبّر، وبذلك كان يناقض في كلّ أحواله(1) من ينكر هذه الحقيقة ويجحدها.
وهذا المتجلّي في المؤمن الملتزم وضدّه من الأحوال المتناقضة المركّب بعضها على بعض؛ هو ناموس وقانون كونيّ مؤسّس على أسباب وجوديّة، شأنه شأن النّواميس الطبيعيّة - السّنن الكونيّة - بلا فرق.
وذلك لأنّ فيه صفة التّلازم المطّرد، وذلك ما به قيام النّواميس والقوانين الطبيعيّة، كما هو معلوم على قطع.
وربّ قائل يقول: إنّ هذا الذي ذكر ليس موجب المغايرة بين الطّرفين، بل قد يكون شيئًا آخر غيره.
نعم، إن كان هذا موجودًا، فليذكر، وليبيّن ما هو؛ فالتّشوّف إلى هذا قائم بالنّفوس الّتي تحبّ الحقيقة وتبحث عنها، وبذلك فالواجب إيراده علّة، وبيانه على جلاء.
وقد يقول آخر: إنّ السّلطان الجاري عليّ هو سلطاني، فأنا حرّ، وملك نفسي لي، ولا سلطان لأحد عليّ على الإطلاق.
هذا غير صحيح، الواقع يشهد على ذلك، وذلك أنّ ما سوى الخالق ليس له إلَّا التّصرّف المحدّد بالتّسخير، فما سخّر له فإنّه يتصرّف فيه، وما تخلّف فيه ذلك خرج عن إمرته وحكمه، وهذا بيّن ثابت بالمشاهدة والحسّ، وبدليل العطاء والأخذ - النّزع - والوضع المفروض عليه الّذي يجبر على الخضوع له مكرهًا.
ثمّ إنّه لو كان له الملك لملك غيره بالإرادة والرّضى، ولكانت الأشياء تخلق على وفق إرادته، ولكانت هذه الإرادة سابقة على ذلك.
إذ لا ريب أنّ المخلوق إرادة إيجاده وخلقه سابقة عليه بأدلّة منها:
دليل العناية، والتّقدير والتّدبير المثمر لهذا الانتظام القائم به، والجاري مقتضاه عليه في الظّاهر والباطن، ولهذا الاستعداد الذّاتيّ للإقرار بالحقّ، وإنكاره على وجه معجز يشهد على التّوافق العجيب بين خلقه وتكليفه، ثمّ دليل استحالة ظهور شيء ما على صورة مخصوصة مركّبة على شكل مقصود دون سابق تصوّر له في ذهن الموجد له المظهر له - ولله المثل الأعلى - عن قصد.
وغير ذلك من الأدلّة الّتي ليس هذا موضع بسطها، وتفصيل المقال فيها.
--------------------------
1ـ أعني أحواله النّفسية الّتي منها: الحبّ والكره والتّقبيح والتّحسين والرّضى والسّخط في الأمور المتّصلة بالعقيدة، وبذلك تعلم أنّ الإقرار المذكور وضدّه هما جوهر وأصل الاختلاف والخلاف بين الطّرفين، ما سوى ذلك من أوجه التّضادي الأخرى بينهما فروع عن ذلك.


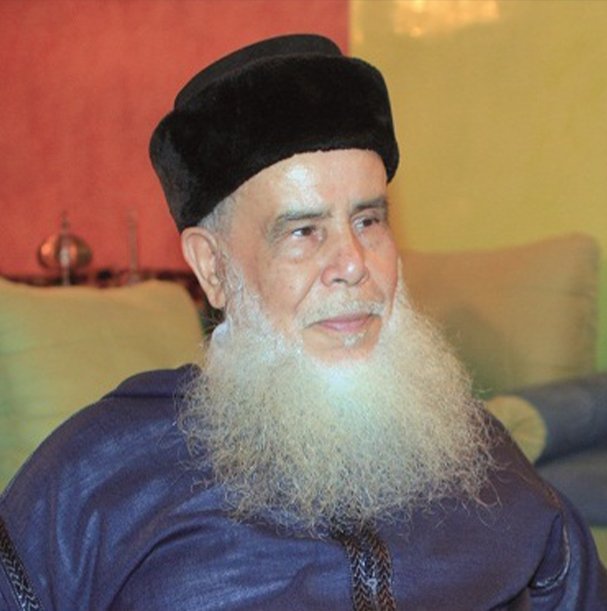




.jpg)





