علامات الفكر المتهافت [2]: فساد المادة.
والمادّة المراد بها: المعلومات المستحضرة والمعتمدة في بناء الأحكام، وهذه المادّة يعلم فسادها بفساد مأخذها، والمأخذ الفاسد يعرَّف هنا بأنّه ما لا ثبوت له ولا قرار، ولا يستند إلى ثابت عقليّ أو واقعيّ، وإنّما هو أمر عرضيّ متخيّل، ومن ذلك ما كان عن المزاج النّفسيّ، الذي مداره على الأهواء والشّهوات.
ومن تأمّل المادّةَ المعرفيّةَ الّتي يعتمدُ عليها العلمانيُّون في أحكامهم على المتديّنين؛ يجد أنّها مادّة مستقاها أمزجتهم النّفسيّة والّتي تقدّم وصف أحوالها، ولا يكادون يخرجون عن مقتضى ذلك، وإن خالل قولهم في هذا الشّأن إيراد بعض الأمور الأخلاقيّة الّتي ما هي في واقع الأمر إلاّ حقّ أريد به باطل.
والدّليل على هذا أنّ كلّ أحكامهم عليهم من هذا السِّنخ، تأمّل ـ مثلا ـ حكمهم عليهم أنّهم "ظلاميّون" و"رجعيّون" وما شابه هذا، فإنّه كلّه يرشدك إلى أنّ مَنْبِتَهُ المزاج النّفسيّ، وذلك أنّ ما يتّصف عندك بالظّلمة النّفسيّة ـ مثلا ـ هو ما أو مَنْ تكرهه؛ وهذا طبع قائم بالنّفوس.
والكره في واقع الأمر قد يكون للباطل، وقد يكون للحقّ، فيسري عليه لون الظّلمة في نفس الكاره، ومن ثمّ يشعر بذلك بما يشعر به من ذلك، وهذا لا يؤثّر في واقع أمر الحقّ شيئا، لأنّه جرى الحكمُ فيه بقلب الحقيقة، وذلك بجعل المزاج النّفسيّ ميزانًا لمعرفة الصّحيح والفاسد، والواجب بمقتضى العقل وموجب الواقع هو جعل الحقّ معيارًا للحكم على المزاج النّفسيّ الذي طبع على التّقلّب ومساوقة الأهواء، ومجاراة الشّهوات الّتي لا قرار لها، ولا حدّ.
وهذا الّذي تقرّر في شأن هذا الحكم يعضده أنّ الظّلمة ليست صفة عقليّة اعتباريّة، وإنّما هي صفة حسّيّة تدرك بحاسّة البصر كما هو معلوم، وبذلك فإنّه لا يتأتّى أن تكون من الأحكام العقليّة إلاّ بواسطة هذه الحاسّة، وهذه الحاسّة لا تدرك في ذوات هؤلاء المتديّنين أيَّ ظلمة أو سواد يجمعهم حقيقة ـ كما ترى ـ.
فإذا تقرّر هذا لم يبق لهذا الحكم - الظلاميّين - أي مأخذ سوى المزاج النّفسيّ المتّصف بالكره، والحقد المعروف أصله، وذاك لا قيمة علميّة له على الإطلاق؛ بل هو علامة كاشفة عن كون الحاكم به عبدًا مطيعًا خاضعًا لمزاجه النّفسيّ.
وفي هذا السّنن أيضا يجري حكمهم عليهم بأنّهم رجعيّون فإنّه لا يعدو أن يكون دليلا على المخالفة النّفسيّة في أمور ترك فيها المنكرون صورا وأحوالا معيّنة، والمنكر عليهم لم يفعلوا ذلك، فجاء وصف الرّجعيّة من ذلك.
والرّجوع ليس أمرًا مذمومًا على كلّ حال، بل قد يكون مطلوبًا إن كان مبنيّا على رعاية جلب المصلحة ودفع المفسدة، وحفظ القيم الشّريفة المبنيّة على رفع قدر الإنسانيّة، وتحصين الفطرة السّليمة، فالمحكوم بأخذه أو تركه من جهة الواقع والعقل مداره على ما تقدّم، سواء حصل العمل بهذا الحكم أم لا.
والنّاس ما سعوا إلى الضّبط بالقوانين إلّا على هذا الأساس، ولهذا الغرض ـ جلب المصلحة ودفع المفسدة ـ ومن خلاف المعقول أن يضبط السّلوك في بعض صور الحياة بهذا ويلغى في بعضها اعتباره ومقتضاه، إذ يعتبر ويقع به الضّبط فيما يدرأ به الضّرر الماديّ، ويلغى أمره وحكمه فيما يقع به الضّرر المعنويّ.
فالسّعي إلى إظهار التَّحرُّر الفكريّ بالتغيير لكلّ ما اعتيد المضيّ على مقتضاه من غير مبالاة بما يترتّب على ذلك من مفاسد ومضارّ؛ سعيٌ في الفساد في الأرض، وأذى الخلق.
فما يسمّى بـ"ـكسر الطّابوهات" أمر يدّعيه بعض النّاس ليظهروا أنّهم على شيء مفيد، والواقع يشهد على أنّ هذا ليس في أصله إلاّ للتّبجّح، وإظهار التّمرّد على أمور قد تكون ضروريّة لبناء المجتمعات على انسجام ووفاق، كما قد تكون نافعة للنّفوس والقلوب.
ولا ريب أنّ انفصامًا محزنا في عرى العلاقة الأسريّة قد حلّ بالمسلمين بسبب هذا التّغيير الضّارّ، وقد كانت هذه العرى من قبلُ محكمة التّداخل والتّماسك بموجب عقيدة الإسلام ومقتضى شرائعه.
وهذا أمر لا ينكره إلّا من يكابر الحقائق، ويجحد ما هو واقع محسوس، فمن هذا الذي لا يذرف دموعه ويوقد ضلوعه أحوال العجائز والشّيوخ وهم مطرحون فيما يسمّى "بدور العجزة" أو "مآوي المسنّين" ولهم أبناء قادرون على رعايتهم، والإنفاق عليهم على الوجه المطلوب المحبوب.
ومعلوم على جزم وقطع أنّ العقوق من الكبائر في دين الإسلام، كما أنّه ينطوي على جفاف الرّحمة والرّأفة من قلوب أهله.
نعم، قد يصدر هذا التّصرّف الخبيث ـ العقوق وما شابهه ـ من آحاد النّاس والتّغريب لم يتلبّس به، والدّعاة إليه در في الظهور، لكن ذلك كان يقابل آتيه بشديد النّكير، والإهانة، والتّحقير في قرارة النّفوس، وفي الواقع، فلا تجد من يلتفت إليه أو يقيم له وزنا، بل يبقى ضحكة في النّوادي، ومضغة يلوكها النّاس في المجالس و"لا غيبة في فاسق"، وربّما صدّ من النّاس والإحسان إليه، جزاء وفاقا.
واليوم من أراد أن يعقّ والديه برميهم في أتون الإهمال منكسرين قد هيضت أجنحتهما، أو أن يدمّر محاسن الأخلاق بدعوى "كسر الطّابوهات" أو أحبّ أن يجُذَّ روابط الأسرة بإنكار الأخوّة و القرابة وما جرى مجرى هذا؛ فإنّ دعاة التّغريب يفتونه بالجواز، بل بالوجوب لأنّه حرّ، وكأنّ الحرّ لا يفعل إلاّ ما يؤذي، وكأنّ تمسّكه بالأخلاق الحميدة ـ كنفع النّاس، واحترامهم، والرّحمة بهم ـ مقيّدًا بها يناقض الحرّيّة.
وبذلك تعلم أنّ ما أتى به هؤلاء المتغرّبون هو تشريع الأذى وجرح النّفوس، وإزالة الرّحمة بالضّعيف، والمحتاج ، (...) ومن قبل كان هذا أمرًا محرّمًا منكرًا.
فكيف يقال بعد هذا بالتّسوية بين الفاحشة في كلا الزّمانين؛ فالفاحشة ـ والأخلاق الحميدة قائمة ـ تجلب التّحقير والإهانة والضّرر، أمّا اليوم ففعل الفاحشة جالب للمدح والثّناء من دعاة التّغريب ومن على سبيلهم، وبذلك شرّعوا ما تقدّم ذكره،.
والواقع والحسّ يدلّ على هذا بقطع وجزم.
ومثل هذا إيلام النّاس بإذلالهم وإهانتهم بأمور هم غير معتادين على تحمّلها، فإيقاعها عليهم كسر لكرامتهم، وخفض لقيمتهم المعنويّة في مجتمعاتهم، حتّى إنّهم يتوارون عن أنظار الخلق من جرّاء ما قام بهم من الشّعور بالمذلّة والعار.
وهذا يأتي من جهة إصابة العرض والشّرف؛ الذي هو قيمة عظمى بمعيار الفطرة السّليمة والحقيقة الإنسانيّة.
والحكمة الّتي مأخذها احترام حقّ الإنسان وثبوت الحرمة له تقتضي عكس هذا الأمر ـ الإهانة والإذلال ـ وتوجب خلافه قطعا.
هب أنّ الحقوق تعارض مقتضاها فهل من الإنصاف أن يراعى في إثباتها طرف دون آخر؟ أما كان من مقتضيات العدل إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ؟!!
نقول هذا على سبيل التّنزّل فحسب، وإن كنّا نعلم على قطع بأنّ المشروع من الخالق لا يمكن أن يعارضه إلاّ الباطل.
وإذا تقرّر هذا الذي ذُكر من أنّ وصف الملتزمين بالدّين بالرّجعيّين والظلاميّين منشؤه المزاج النّفسيّ لا النّظر الصّحيح، والفكر الموضوعيّ؛ أدركتَ أنّ مثل هذه الأوصاف ـ الأحكام ـ لا قيمة معرفيّة له، وأنّه إنّما يبتدره من لا يعظم حظّه من فهم الواقع البشريّ، والحقائق القائمة به.
وإنّما اقتصرنا على ذكر الوصفين ـ الحكمين ـ للاختصار والتّمثيل بهما فقط، إذ كلّ أحكام أولئك ـ العلمانيّين ـ على هؤلاء ـ المسلمين الملتزمين بدينهم ـ من هذا الصّنف بلا فرق.
وبذلك تعلم أنّ المادّةَ المعرفيّة لدى العلمانيّين في شأن أمور الدّين والملتزمين بها؛ مأخذها المزاج النّفسيّ ـ كما تقدّم تقريره ـ وصاحب المزاج النّفسيّ الخالص حكمه كحكم النّائم والغافل والسّكران، والواقع والحسّ المدرك له يشهدان على ذلك بجزم، فتأمّل بإنصاف...
مأخذ المادّة المعرفيّة الدّينيّة:
المعارف والعلوم الدّينيّة الإسلاميّة مرجعها البرهانيّ في نهاية الأمر إلى ما اقتضته العقول السّليمة وحكمت به على قطع من ثبوت الملك والتّدبير للخالق الفاطر لهذا الكون، أخذا من البراهين والحجج القائمة في واقع الكون وبه، وهو أمر لا يصدّ عن الإقرار به إلَّا العناد ومرض الطّغيان، والكبر وتأليه النّفس المشمئزّة من هذه الحقيقة.
والقول الدّينيّ إذا ثبت بالبرهان والحجّة أنّه من الخالق يصير علمًا برهانيّا، والاستعلاء على مفاده ومقتضاه بعد ثبوته كذلك مناقض للعقول والبراهين الواقعيّة، إذ العبرة في هذا الأمر بما ينتهي إليه النّظر من البناء على الأدّلة البرهانيّة الأصليّة.
والمقرّر بالأدلّة في العلم الشّرعيّ الإسلاميّ أنّه ما يؤخذ منه هذا العلم وما يؤخذ به؛ كلّه يجب أن يكون من لدن ربّ العالمين، ويعرف ذلك من نصوص القرآن أو من البيان النّبويّ. وهذا المبدأ إدراكه بالتّفصيل وعلى وضوح؛ يتوقّف على الاطّلاع على المراجع العلميّة الإسلاميّة الّتي انطوت عليه مبيَّنًا.
ومن طلب بيان أصول ومآخذ وطرق استحصال ما ينسب إلى هذا الدّين من مقالات فهو على الحقّ ماض، فوصمه بأنّه مدّع للوصاية على الدّين باطل، لأنّ ذلك البيان يحصل به تمام الإدراك لحال كلّ مقالة دينيّة، وبصحّة الإسناد والثّبوت لما هو من الخالق ـ سبحانه ـ تصحّ تلك المقالة، وبتخلّف ذلك فيها يصار إلى الحكم عليها بالبطلان.
خلاصة القول: إنّ المقدّمات المستعملة في العلوم الشّرعيّة بعضها مبنيّ على بعض في مجرى بيان مآخذها ومعتمداتها العقليّة حتّى ينتهي الأمر إلى ما تقدّم ذكره من البرهان الأصليّ، وثبوت الملك والأمر للخالق الذي بيده ملكوت كلّ شيء، ولا مطلب للعاقل وراء هذا، وإن حاول.


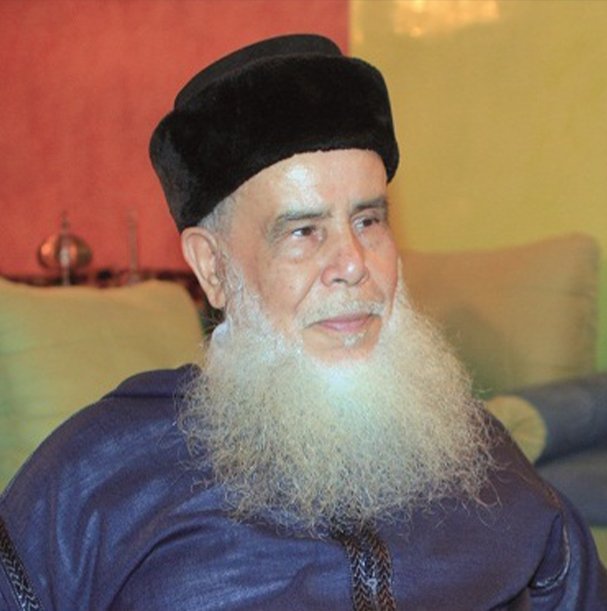




.jpg)





